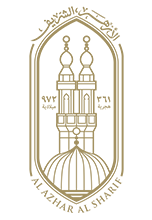من القرى إلى القبائل: قراءة في تحوّل البنية الاجتماعية والسياسية في الوجه البحري

بقلم: بهجت العبيدي
منذ أواخر عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، بدأت ملامح جديدة تتشكّل في المشهد الاجتماعي المصري، خاصة في محافظات الوجه البحري. لم يكن مألوفا أن تتخذ العائلات الكبيرة موقعا سياسيا صريحا، أو أن تُعقد المؤتمرات باسمها لإعلان التأييد أو المبايعة، كما صار الحال في العقدين الأخيرين.
تاريخيا، كان هذا النمط من التنظيم الاجتماعي يتركز في الصعيد حيث البنية القبلية أقدم وأكثر رسوخا، وحيث تضطلع القبيلة بدور مركزي في ضبط العلاقات الاجتماعية وتسوية النزاعات. أما في الوجه البحري، فقد كانت الروابط العائلية قائمة، لكنها لم تكن تُستثمر سياسيا أو تُمارس نفوذا عاما بهذا الشكل الواسع.
ولذلك فإن انتقال هذه الظاهرة من الصعيد إلى الدلتا لا يمكن أن يُقرأ بوصفه صدفة، بل تحوّلا بنيويا يعكس تغيرا في علاقة المواطن بالدولة، وفي الطريقة التي تُدار بها السياسة والمجتمع على السواء.
من المهم أن نُدرك أن القبلية الجديدة في الوجه البحري ليست “عودة رومانسية” إلى الماضي، بل هي إعادة توظيف اجتماعي للروابط التقليدية في سياق سياسي معاصر.
فمع تراجع دور الأحزاب وانكماش النقابات وضمور المشاركة السياسية المؤسسية، وجدت الدولة نفسها تعتمد، في كثير من الأحيان، على ما تبقى من شبكات اجتماعية فاعلة لضمان الاستقرار وحشد التأييد — أي على العائلات الكبرى والزعامات المحلية.
النظام الانتخابي بدوائره الحالية، والاعتماد المفرط على العلاقات الشخصية، جعلا الولاء العائلي وسيلة لضمان النفوذ السياسي. وهكذا تم تشجيع العصبيات الصغيرة لتكون أدوات ضبط اجتماعي وتحشيد سياسي، في مقابل تراجع مفهوم المشاركة المدنية القائمة على البرامج والأفكار.
يتوازى هذا التحول مع تراجع ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة. حين يعجز المواطن عن الوصول إلى العدالة السريعة، أو يجد أن الخدمات لا تُمنح إلا بالواسطة، يلجأ إلى البنية الأكثر أمانا بالنسبة له: العائلة.
العائلة هنا ليست فقط رابطة دم، بل مؤسسة موازية للدولة تؤمّن الحماية، وتوفّر الواسطة، وتُعيد الاعتبار للفرد في مواجهة بيروقراطية ضخمة لا تراه إلا رقما في طابور طويل.
لكن هذه “الدولة العائلية” بطبيعتها غير ديمقراطية، لأنها تقوم على الولاء لا على القانون، وعلى العصبية لا على المساواة. إنها استجابة اجتماعية مفهومة، ولكنها في الوقت ذاته تُقوّض أسس الدولة الحديثة التي ناضلت أجيال لبنائها منذ فجر القرن العشرين.
حين تتعدد الولاءات داخل المجتمع – للعائلة، أو للعشيرة، أو للزعيم المحلي – يبهت الولاء الأكبر للدولة.
وحين يصوّت المواطن استجابة لقرابة الدم لا لقناعة البرنامج، يتحوّل النظام السياسي كله إلى سوق للولاءات، يفقد فيه الصوت الانتخابي معناه المدني.
هذه ليست أزمة إجرائية، بل أزمة وعي وشرعية، لأن الدولة الحديثة لا تقوم إلا على عقد اجتماعي يقوم على الحقوق والواجبات المتساوية.
تأتي القبلية السياسية، في المقابل، لتعيد إنتاج مجتمع هرمي لا يرى الأفراد إلا عبر مواقعهم داخل البنية العائلية، فيتحوّل المواطن إلى تابع، وتتحوّل المواطنة إلى امتياز.
وبكل تأكيد لا يمكننا تجاهل البعد الاقتصادي.
فمع تفكك ملكية الأرض وتراجع الزراعة وصعود اقتصاد الخدمات والوساطة، أصبحت العائلة شبكة الأمان الاقتصادي، والممر الذي تُوزّع عبره الفرص.
المقاول الصغير يجد عمله بفضل قريب نافذ، والموظف يُعين بشفاعة ابن عمّه، والشاب يهاجر بمعونة العائلة.
هكذا تتحول القرابة إلى عملة اجتماعية واقتصادية في آن، وتُعاد هندسة المجتمع على أساس شبكات مغلقة من المصالح المتبادلة.
إن المستفيدين لهذه العودة القبلية كُثر: النخبة المحلية التي تضمن استمرار نفوذها. وكذلك السلطة المركزية التي تجد في هذه الشبكات أدوات للضبط دون تكلفة مؤسسية. وبكل تأكيد رجال الأعمال والوسطاء الذين يستثمرون الولاءات العائلية لتسيير مصالحهم.
أما الخاسر الأكبر، فهو فكرة الدولة الوطنية ذاتها — تلك التي يفترض أن تساوي بين أبنائها دون النظر إلى أصولهم أو روابطهم. الخاسر هو المواطن الذي لا يجد لنفسه مكانا إن لم يكن “من العائلة”، والشاب الذي يُسأل قبل أي امتحان عن “ابن مين في البلد”.
إن هذا النمط الذي عُمِل ومازال يعمل على ترسيخه لا يمكن أن يزول بقرار أو بخطاب، بل بإعادة بناء الثقة في المؤسسات المدنية الحديثة.
وإذا كان هناك نية حقيقية لإصلاح ما تفسده مثل هذه الظواهر والتي تجد من يتبناها ومن يرسخها فالطريق معلومة حيث لابد من تفعيل العدالة المحلية والمؤسسات الوسيطة لحل النزاعات بدل الجلسات العرفية. وإصلاح منظومة التعليم والإعلام لترسيخ قيم المواطنة لا العصبية، بالإصافة إلى تمكين المجتمع المدني الحقيقي ليكون شبكة بديلة للتكافل. فضلا عن تجفيف منابع الفساد والمحسوبية التي تعيد إنتاج التبعية.
والخلاصة التي نذهب إليها أن القبلية في الوجه البحري ليست “إحياء للتراث”، كما قد يتصور البعض، بل هي عودة اضطرارية إلى الوراء حين تفشل الدولة في أن تكون حاضنة للمجتمع.
إنها صرخة صامتة من مجتمع يبحث عن الأمان وسط اضطراب التحولات. إن الأمان الحقيقي لا يأتي من انغلاق رابطة الدم، بل من انفتاح القانون، ولا من الولاء للأسماء، بل من الولاء للمبادئ.
ومصر — بتاريخها العريق في بناء الدولة منذ الفراعنة حتى محمد علي — تستحق أن تبقى دولة مواطنة وعدل، لا دولة عائلات ونفوذ.
إنها لحظة تستدعي أن نعيد السؤال القديم الجديد:
هل نبني وطنا يضم الجميع تحت راية القانون، أم نكتفي بظلّ عائلة تحمينا من دولة غائبة؟