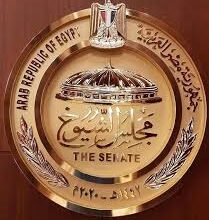صدى الترند .. ومشروع فرج فودة “التنوير الذي لم يكتمل”

بقلم الدكتورة نبيلة رشدي
بطاقة تعريف: فرج فودة
يُعدّ فرج فودة (20 أغسطس 1945 – 8 يونيو 1992) كاتبًا ومفكرًا مصريًا بارزًا، وُلد في مدينة الزرقا بمحافظة دمياط، حصل على درجة دكتوراه في الاقتصاد الزراعي من جامعة عين شمس، ثمّ عمل مدرسًا وخبيرًا في شؤون الزراعة والتنمية، وشرع منذ ثمانينيات القرن العشرين في إنتاج فكري نقدي متميز.
إن مشروعه الفكري تركز على أربعة محاور رئيسية: نقد التيارات الإسلامية السياسية، الدعوة إلى الدولة المدنية، فصل الدين عن الدولة، والدفاع عن حرية الفكر والتعبير. في يناير 1992 شارك في مناظرة عنوانها «مصر بين الدولة الإسلامية والدولة المدنية» في معرض القاهرة للكتاب، والتي شارك فيها عدد كبير من التيارات الفكرية والدينية، وكانت لحظة فارقة في مسار فودة، بعد عدة أشهر اغتيل أمام مكتبه في القاهرة على يد أفراد من جماعة “الجماعة الإسلامية” إثر اتهام بالتكفير من بعض العلماء.
أعماله تشمل كتبًا مثل الحقيقة الغائبة، حوار حول العلمانية، الطائفية إلى أين؟ وغيرها، وهي أعمال لا تزال تُناقش حتى اليوم في سياقات الفكر والحداثة في العالم العربي.
إرث فودة وعلاقته بما تمثّله ابنته:
لقد شكّل فرج فودة رمزًا للتنوير العربي بجرأته في مواجهة الخطاب الديني والسياسي المغلق، وكان مشروعه الفكري متينًا يقوم على منهج نقدي عقلاني، غايته تحرير العقل من سلطة الوهم، وإعادة بناء الوعي على أسس معرفية رصينة، غير أن ظهور ابنته سمر فودة في السنوات الأخيرة – عبر منصات التواصل – قد أثارت جدلاً واسعًا حول طبيعة الإرث الفكري وأحقية تمثيله، فخطابها لا ينتمي إلى المدرسة العقلانية التي أسّسها والدها، بل يبدو في كثير من الأحيان خطابًا انفعاليًا، متسرعًا، ومشحونًا بنزعة صدامية مع المجتمع أكثر من نزعة إصلاحه.
يمكن القول إن سمر فودة لا تواصل فكر والدها بقدر ما تستثمر رمزيته، فبدلاً من أن تكون صوته الجديد في مناقشة قضايا التنوير والحرية والهوية، تحوّلت إلى ظاهرة إعلامية مثيرة للجدل، تتخذ من الصدمة وسيلة للتعبير، ومن مواقع التواصل منبرًا لتسجيل مواقف سريعة لا تنتمي إلى العمق النقدي الذي ميّز أباها، إنها تعبير عن تحوّلٍ ثقافي في طريقة تلقي الأفكار نفسها: من المناظرة والمنهج إلى الترند والانفعال.
وهنا تكمن المفارقة: فبينما كان فرج فودة يواجه الظلامية بقوة المنطق والحجة والبحث التاريخي، نجد أن ابنته تواجه المجتمع بروح التحدي الشخصي لا الفكري، فتُعيد إنتاج الصراع في صورةٍ جديدة من “الاستفزاز” بدل “التنوير”.
ولذلك يمكن القول أن ابنته تمثل الوجه المعاصر لتشوّه الخطاب العام في الفضاء العربي، حيث يُختزل الفكر في الجدل، والعقل في الصخب الإعلامي.
ومع ذلك، فإن حضورها يذكّرنا – ولو سلبًا – بأن أفكار التنوير لم تكتمل بعد، وأن ما بدأه فرج فودة ما زال بحاجة إلى أصوات جديدة تحمل منطقه لا اسمه، وعقله لا شعاره، حتى لا يتحوّل إرثه من فكرٍ حيّ إلى ظلٍّ فارغ يُثير الضجيج دون أن ينير الطريق.